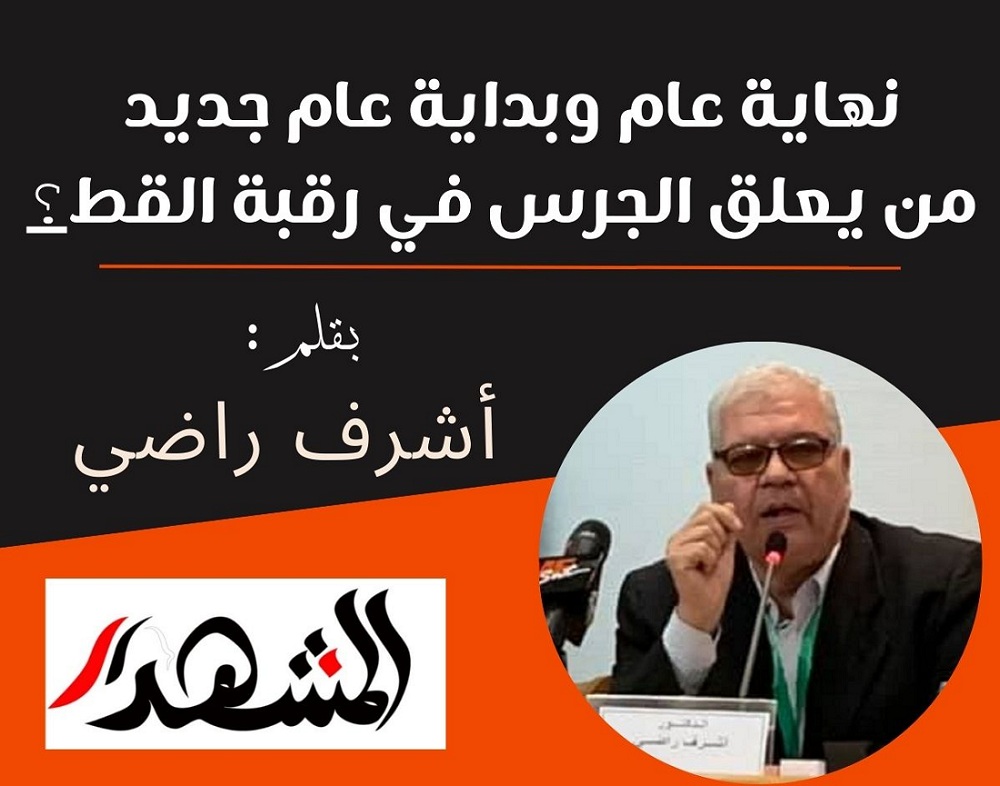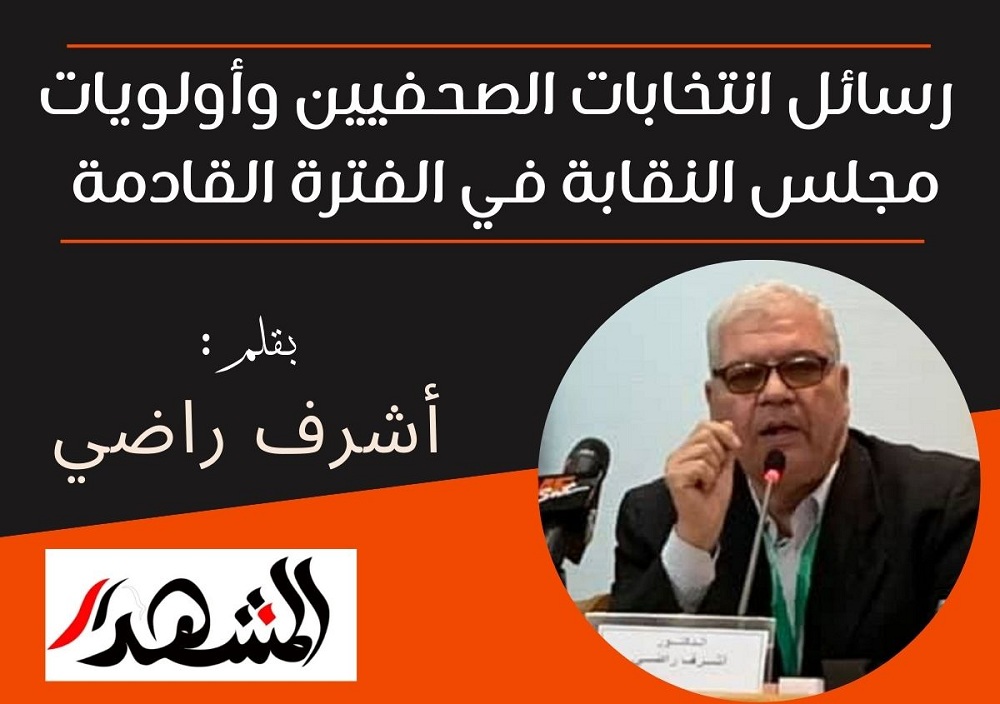من المؤكد أن سؤال السياسة الرئيسي المتعلق بالتغيير، لا يتعلق بما يجب أن يكون وإنما معنيٌ أساساً بكيفية إحداث هذا التغيير المنشود، انطلاقاً مما هو قائم بالفعل عبر خطة مدروسة واضحة الخطوات ومحددة الإجراءات تستجيب للتحديات وتبحث في الممكنات، فالسياسة في أحد تعريفاتها هي "فن الممكن". لا يتعلق الأمر، هنا، بمن في يده الحل وإنما يتعلق بمعقولية الحل وقابليته للتطبيق. قد يتصور البعض أن هناك فارقا بين النظم الديكتاتورية وبين النظم الديمقراطية في هذا الأمر، ويرى أن المشكلة تكمن في النظم الاستبدادية لأن الحكومات المستبدة تملك حل المشكلات المختلفة، وأن الأمر مرهون بإرادتها. في كثير من المناقشات التي أشارك فيها أو أحضرها يبدأ تناول المشكلات والقضايا المختلفة أو ينتهي بالإشارة إلى غياب الإرادة السياسية لتبني الحلول المقترحة.
في مقال لعالم سياسة مصري ينتمي إلى مدرسة التفكير الواقعي، وشغل منصباً وزارياً ومناصب سياسية استشارية مرموقة، كتبه في تسعينات القرن الماضي، تعرضّ للفكرة السائدة لدى النخبة والجمهور الواسع التي تعتقد أن رئيس الجمهورية، خصوصاً في نظم الحكم الاستبدادية غير مقيد في تصرفاته وقراراته، وكي لا يسئ أحد الفهم، فإن القيود المشار إليها في المقال وهنا، لا تنصرف فقط إلى القيود التي تفرضها قوى خارجية تتمتع بنفوذ في الدولة وإنما تشير أيضاً إلى القيود الداخلية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين أو نلك التي تفرضها موازين القوى داخل المجتمع.
لنفترض مثلا أن حاكما مستبداً ضاق ذرعاً بالفساد المستشري في بلده، وقرر فجأة مواجهة الفاسدين وشبكاتهم، هل سينجح أم أن هذه الشبكات أقوى من الرئيس وتستطيع فرض مصالحها عليه؟ لقد لمس فيلم "طباخ الرئيس" هذه المشكلة، وأوضح كيف تتغلغل هذه الشبكات في الدائرة المحيطة بالرئيس، التي تنقل له التقارير عن الأوضاع الداخلية، والتي يتم من خلالها التأثير في القرارات السياسية وإتاحة ما يخدم أهدافها من تقارير ومعلومات وحجب التقارير والمعلومات التي تؤثر على تلك المصالح. وهناك فيلم أمريكي يشرح كيف سيطرت مؤسسات الدولة وتنفيذ القانون على أباطرة المافيا في الولايات المتحدة والتصدي لنفوذها في دوائر السلطات المحلية والفيدرالية، وهو النفوذ الذي يتجلى في فيلم "الأب الروحي" بأجزائه الثلاثة.
البريكاريا: طبقة اجتماعية جديدة وخطيرة
في عام 2011، أصدر البروفسور جاي ستاندينج أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة باث البريطانية، كتاباً بعنوان "البريكاريا: الطبقة الاجتماعية الجديدة"، نحت فيه مصطلح "البريكاريا" المستحدث، الذي يشير إلى مفهوم اجتماعي اقتصادي، جرى تطويره من لفظ منحوت من مصطلح "البروليتاريا" المستخدم في أدبيات الاقتصاد السياسي. ويصف مصطلح "البريكاريا" طبقة اجتماعية تشكلت في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش، نتيجة لسياسات الليبرالية الجديدة التي أدت إلى شيوع حالة من الشك وعدم اليقين وعدم الائتمان على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وأن هذه القوة المتنامية التي تتخذ ملامح الطبقة الاجتماعية، هي القوة الدافعة للتوجه إلى التطرف والشعبوية، ويُساعد هذا الفهم الذي يقدمه ستاندينج، والذي يستكمل نظرية عالم الاجتماع الألماني أولريش بيك الذي طوَّر نموذج "مجتمع المخاطر العالمي" لفهم التحولات العميقة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة منذ سبعينيات القرن الماضي، والناجمة عن سياسات الليبرالية الجديدة، والتي تفرز مشكلات تضع الحكومات والنخب أمام اختيارات صعبة.
لقد أثرت هذه التحولات التي يشهدها العالم على طريقة تفكيرنا، وأدت إلى تطوير نماذج في علم المنطق تستجيب لحالة عدم اليقين وتشوش الرؤية، التي أصبحت سمة سائدة لكثير من السياسات في العالم. ولخص بيك هذه الحالة في كتابه "مجتمع المخاطرة العالمي"، بقوله إن التطورات الجديدة التي مرت بها المجتمعات الغربية نتيجة ما أسماه "برزلة العمل"، والتي تعني تخلي المجتمعات الأوروبية عن نموذج "الكسب من خلال العمل" الذي ساد في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي يضمن لكل شخص وظيفة تتناسب مع مؤهلاته، وضعت الجميع في مواجهة وضع قلل من قيمة وأهمية ما تعلمه الفرد من معرفة وما اكتسبه من خبرة ومهارات، أو جعلها بلا قيمة، والأخطر أنه في ظل هذا الوضع الجديد لا يوجد ما يرشد الفرد إلى نوع المعرفة أو التعليم أو الخبرة أو المهارة اللازمة لضمان وظيفة مناسبة. إن توفير الوظائف وفرص العمل، هي إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومات الغربية، وتحتل هذه القضية الحيز الأكبر في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة على السلطة في تلك المجتمعات.
و"الكسب من خلال العمل" هو المكون الأساسي الذي استندت إليه صيغة العقد الاجتماعي في كثير من البلدان التي استقلت عن الاستعمار في الخمسينات والستينات، والتي اتبعت سياسات اقتصادية، هي أقرب ما يكون إلى السياسات التي دعا إليها الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز (1883–1946)، لانتشال العالم من الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات، والمتمثلة في خلق وظائف وهمية لتحفيز الاقتصاد من خلال توليد دخول وقدرة شرائية في المجتمع، متغاضيا عن قانون الغلة المتناقصة، والذي يشير إلى نقطة حرجة تنكسر عندها العلاقة الطردية بين الجهد المبذول وانتاجية العمل، لتبدأ في التحول إلى علاقة عكسية، وهو القانون الذي على أساسه يتم تحديد الطاقة البشرية القصوى التي يحتاجها مشروع من المشروعات، والذي على أساسها يتم التخلص من العمالة الزائدة في برامج الإصلاح الهيكلي، التي تنفذها الشركات والحكومات.
للاقتصاد قوانين صارمة تعمل باستقلالية عن وعينا بها، وتفرض نتائجها على الجميع، ولا يكون بوسعنا سوى استنباط حلول سياسية واجتماعية للحد من آثار وتكلفة تلك القوانين، والتخطيط الواعي والمدروس من أجل احتواء التطورات غير المرغوبة الناجمة عن النشاط الاقتصادي لكن دون تجاهل القوانين التي كشفها العلم الذي يدرس النشاط الاقتصادي للمجتمعات والأفراد، ويجب على أي سياسات الوعي بهذه القوانين والانطلاق منها، لكن هناك أيضاُ خطورة في الاستسلام لهذه القوانين وعدم مراعاة الجوانب الاجتماعية والسياسية والتعامل معها. إن انفضاض العقد الاجتماعي الذي كان ركيزة للاستقرار السياسي والاجتماعي في كثير من المجتمعات بفعل التحولات التي شهدها العالم منذ السبعينات، ونتيجة فشل نماذج التخطيط الاقتصادي المركزي في الاتحاد السوفيتي والدول التي سارت في فلكه، يشكل تحولاً خطيراً في الأساس الاقتصادي الاجتماعي للسياسة وفن الحكم، ويعمل على تقويض الركيزة الرئيسية الثانية للاستقرار السياسي المتمثل في رضا المحكومين عن حكوماتهم، والاعتماد أكثر على الركيزة الثانية وهي الإرغام والإكراه.
فقر الفكر وفكر الفقر
على الرغم من وجود نماذج في الرأسمالية العليا التي استطاعت الحفاظ على نموذج دولة الرفاه المتراجع في كثير من المجتمعات بسبب تعميق الفجوة بين الأثراء والفقراء، وهجوم "الليبراليين الجدد" على الليبراليين، الذين يدافعون عن ضرورة مكافحة الفقر من خلال برامج اجتماعية وسياسية، إلى حد اتهامهم بالانحراف اليساري وبالشيوعية، مثلما رأينا في خطاب الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس، مرشحة الجزب الديمقراطي، ومحور الخلاف بين المحافظين والليبراليين الجدد وبين الديمقراطيين والديمقراطيين الاجتماعيين يتمثل في السياسات الضريبية، إذ يميل المحافظون الجدد والشعوبيون اليمينيون إلى تقليل الضرائب من أجل تحفيز الاستثمار الذي يوفر المزيد من فرص العمل واتباع سياسات حمائية تتعارض مع مصالح المستثمرين الداعمين لفتح الأسواق واستغلال قوة العمل على صعيد عالمي. يقابل هؤلاء الشعبويين من اليمين شعبويون من اليسار والفوضويون، وربما كانت نقطة الاتفاق الوحيدة بين الفريقين هي إيمانهم القوي بالدور الذي يلعبه العمل المباشر وسياسات القوة والعنف في إحداث التغيير، في مؤشر على تراجع السياسة. إن خطورة هذا النمط من التفكير تتمثل في أنه يفتح الباب لصراعات عنيفة وصفرية.
هذا هو فكر الفقر الناتج عن قانون الثراء والفقر الذي يشير إلى أن السياسات الرأسمالية تعمل على تعميق الفجوة بين الأثرياء الذين يزدادون ثراء، وبين الفقراء الذين يزدادون فقراً في غيبة أدوات لتوزيع الدخل، والناجم عن أزمة الفكر الاشتراكي وأزمة الليبرالية، وهما انعكاس لأزمة الرأسمالية العالمية التي تعبر فقر الفكر وتراجع القدرة على إنتاج بدائل للوضع الراهن وإنتاج حلول عملية للخروج من الأزمات الناجم عن تعميق التناقضات واحتدام الصراع بين الفريقين، خصوصاً مع تعظيم الأسس الأيديولوجية والعقائدية لهذه الصراعات نتيجة لغياب أسسها المادية أو تغييبها، وفي ظل هذا الفقر الفكري، تتقدم القوى الرجعية والمحافظة والفوضوية لتصدر المشهد وإدامة الصراعات العنيفة. في هذه اللحظات الدقيقة التي أفرزت من قبل حكومات فاشية متصادمة، قادت العالم إلى حربية عالمية اندلعت عام 1939 واستمرت خمس سنوات، ولم تتعلم البشرية الدرس على ما يبدو. وبينما لعب توازن الرعب النووي بين المعسكرين المتحاربين بعد الحرب العلمية الثانية دوراً في وضع سقف للحروب، إلا أن احتدام الصراع بين القوى الكبرى قد يصل إلى مدى ينهار معه الردع النووي. وهذا الوضع يفسر انتشار النظريات والآراء التي تتحدث عن حروب نهاية العالم، التي تتحول إلى ما يشبه النبوءة المحققة لذاتها خصوصاً مع تراجع الأصوات التي ترى أن بالإمكان التراجع عن هذه السياسات وتبني سياسات بديلة.
إن الحديث الذي يقصر امتلاك إرادة سياسية على الحكومات فقط لا يساعد على استكشاف ممكنات للحركة والفعل الدافعين للتغيير الإيجابي. إن المثال الذي تقدمه قصة الفئران والقطط والتي تشير إلى قانون طبيعي لا يمكن للفئران ولا القطط تغييره، إذ ستظل القطط تأكل الفئران ولا يسع الفئران سوى الفرار من القطط لتفادي وقوعها في المصير المحتوم، والسؤال هو هل المجتمعات محكومة بحتمية قوانين الطبيعة مثلما هو الحال في عالم الحيوان، ولا يوجد بديل أمام المجتمعات الإنسانية سوى الاستسلام لمصيرها المحتوم، لعدم قدرتها على تعليق الجرس في رقبة القط؟ الإجابة الأرجح لدي هي لا، لامتلاك البشر قدرات على الابتكار والإبداع والتخيل، وفي التاريخ القديم والحديث ما يدعم تلك الحقيقة. إن نشر مثل هذا التفكير المحبط للفعل الإنساني والذي يقلل من قيمة الإنسان مرتبط بتلك القوى التي لا ترى حلاً لمشكلة الفقر إلا بالتشجيع على قتل الفقراء، من خلال صراعات وحروب دولية وأهلية، ولا يمكن للدول الفقيرة على الصعيد العالمي، ولا يمكن للفقراء في المجتمعات المحلية الإفلات من هذا المصير إلا بالتحرر من هذا النمط من التفكير الذي يرى التاريخ يمضي في مسار حتمي، وهي فكرة يجري تغليفها بالدين.
لنعلق الجرس في رقبة القط ونتحرر من الفكر الذي تعمل قوى كبرى على ترويجه بوعي ونردده نحن بجهل، إن التفكير في الصراعات التي نشهدها في العالم والتي يجري وضعها في سياقات قومية (الحرب الأوكرانية) أو في سياقات دينية-إثنية أو مذهبية أو قومية (الحرب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط)، بمعزل عن التحولات في الاقتصاد السياسي العالمي الناجمة عن سعى القوى الرأسمالية لحل أزمتها على حساب الشعوب، لا يعني سوى دفع العالم إلى حرب شاملة لن تكون محصلتها مثل ما سبق من حروب لأن تبعاتها معروفة للجميع، على الشعوب أن تتحرك الآن لتحرر نفسها من زعماء يرون في إدامة الحرب مخرج من أزماتهم الداخلية. وليكن النداء في عام 2025، "معا من أجل وقف الحرب"، ذلك أن استمرار الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، وحرب غزة وما يرتبط بها من حروب ومواجهات عسكرية أخرى في المنطقة ينذر بأن تخرج هذه الحروب عن السيطرة، ولعل خطاب المرشح الجمهوري ترامب الذي ركز على أنه لو كان في الرئاسة ما اندلعت تلك الحروب تأكيده على سعيه لوقفها هو العامل الأساسي في الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات، ومن المهم أن يمتلك الأدوات والوسائل والرؤية التي تمكنه من تحقيق ذلك الهدف، وفي هذا تحول عظيم.
امتلاك إرادة التغيير الواعية
إن التطورات التي تشهدها مصر والمنطقة على خلفية السياسات الاقتصادية المتبعة التي تعكس أولويات تستدعي إعادة نظر جذرية وشاملة خصوصاً في ضوء تصريحات محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، خلال اجتماعه مع مجموعة من المستثمرين يوم الخميس، والتي حذر فيها من التضخم ومن هروب الاستثمارات والشركات من مصر وحديث رجال الأعمال عن صعوبة الاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، ومن قبل تصريحات أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، الذين غسلوا يد الصندوق من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما بزيادة أسعار المحروقات والدعم. لا يمكن الخروج من هذا الوضع إلا بإعادة النظر في أولويات السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية وطرح برنامج لتعديل الاختلالات الاجتماعية التي ترتبت على السياسات الاقتصادية الذي تتكشف الحاجة الماسة إليه، وإعادة توجيه الاستثمارات الموجهة لمشروعات للقيمة المضافة التي تعتمد على التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية ورفعها.
ولا يمكن لمصر أن تتعامل مع التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة نتيجة للحرب في غزة والحروب المرتبطة بها على الجبهة اللبنانية وفي الضفة الغربية وفي سوريا واليمن وغيرها من جبهات، وما ترتب عليها من تغيير سياسي في سوريا إلا بإعادة بناء الجبهة الداخلية وتقويتها، وهذا يتطلب مواجهة شاملة لأوضاعنا السياسية والاجتماعية بما يعزز الركيزة الثانية للحكم (الرضا) لدعم الركيزة الأولى (الإرغام والإكراه) والتخفيف من وطأة ارتكاز عليها، وإدراك أن أساليب الدعاية المتبعة وسائل الإعلام المؤممة لا يمكنها ستر هذا الخلل في عصر السموات المفتوحة والفيض المعلوماتي الذي يتيح للمواطنين وسائل مختلفة تمكنهم من الاستماع إلى الإعلام الذي يعبر عن هموهم ويسعى لتوظيف استيائهم وسخطهم نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة للتضخم، وزيادة البطالة نتيجة تراجع الاستثمارات المولدة للثروة والدخل.
لقد أضاعت الحكومة فرصا سانحة للعدول عن السياسات الاقتصادية التي تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولم نعد نملك ترف الاستمرار في هذه السياسات في ظل المتغيرات التي تجري من حولنا، نريد سياسات واعية تستجيب للمتغيرات ولا تعيد تكرار أخطاء النظام السابق، واهمة أن في ذلك حل لما نعانيه من مشكلات، الحل في إعادة ترتيب الأولويات الموجهة للسياسات العامة، وفي منح المبادرات الخاصة والمنظمة للمجتمع الحرية الكاملة أو على الأقل عدم التصدي لمحاولة هذه المبادرات العمل بحرية، على الحكومة أن تثق أكثر في هذا الشعب وفي قدراته ولا تقلل منها، وعلينا أن نكون نحن أكثر فيما نملكه من قدرات وأفكار. إن التغيير الواعي بات فريضة على الحكومة وعلى قوى المجتمع.
--------------------------------
بقلم: أشرف راضي